الصفحة الرئيسية / مراجعات / خمسون حكمة حول العالم / الحكمة (33): «وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق» لألفة يوسف
أقف اليوم في محطتي الثالثة والثلاثين: تونس الخضراء؛ ويرى البعض أن خضرتها ليست حصراً على سهولها وغاباتها وأشجارها، وإنما إشارة إلى كثرة انتشار القبب الخضراء التي تعلوا الزوايا الصوفية؛ والزاوية هي المكان الذي يضم حلقات التعليم والحلقات الصوفية، وهو موضع معد للعبادة، والإيواء، وإطعام الواردين، والقاصدين.
أغلب الزوايا اليوم لا تعدوا أن تكون مزاراً سياحياً أو خربة مهجورة، ولكن ثقافة الزوايا والرجال الصالحين المنسوبة إليهم لا تزال حاضرة في الثقافة التونسية وعمقها الصوفي والروحي. وامتداداً لهذا الموروث الثمين، تقدم ألفة يوسف كتاب «وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق» الذي نشرت طبعته الأولى دار مسكيلياني للنشر والتوزيع في سنة 2019 في تونس.
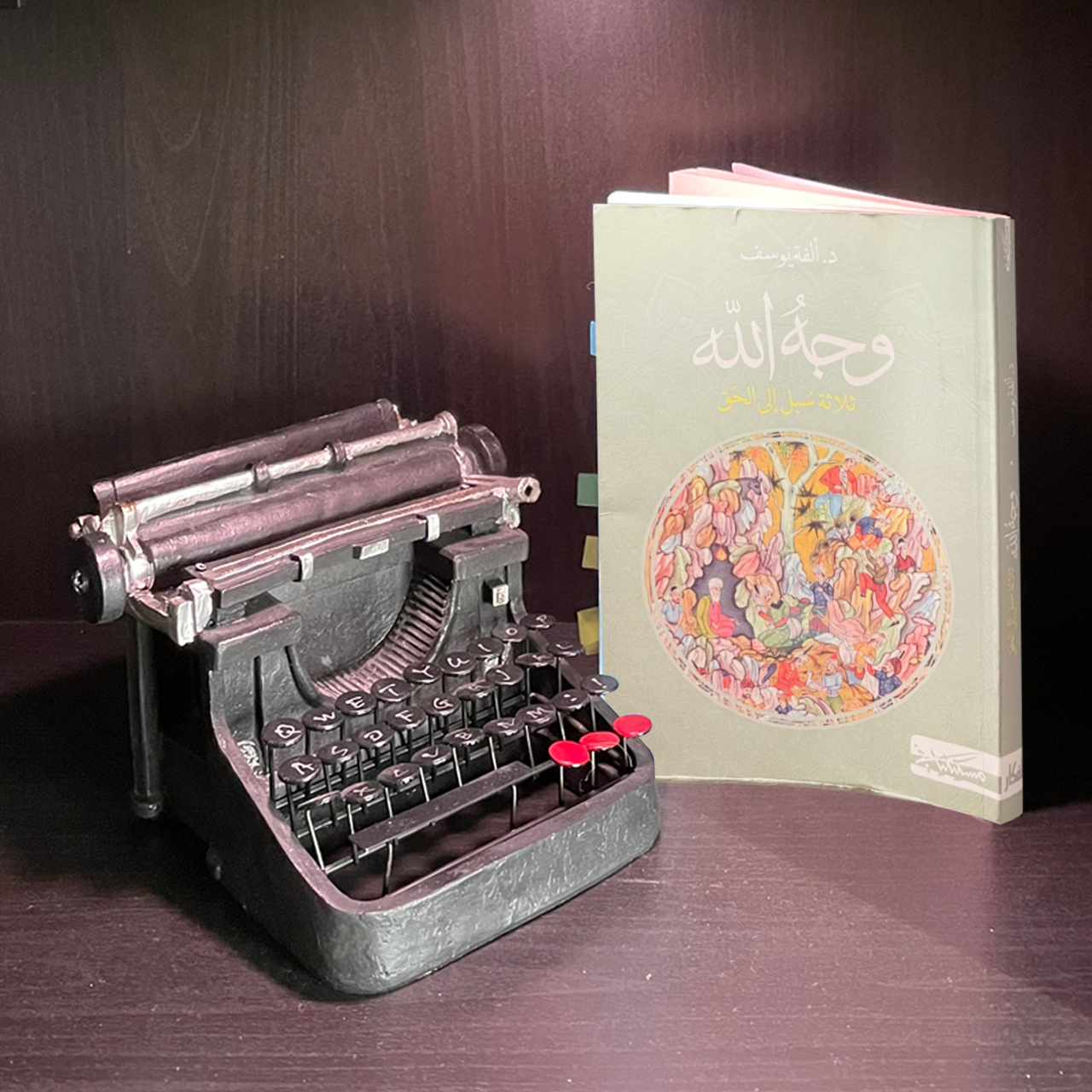
تتحدى ألفة يوسف في كتابها الفريد أغلب المفاهيم السائدة في المجتمعات المسلمة عن الله -عز وجل- وعلاقتهم به، والفريد في الكتاب هو استنادها في العديد من التفسيرات إلى المقولات السائدة في اللهجة التونسية من قبيل: “الله غالب” و”على مراد الله”.
وكما ذَكرَت في مقدمة الكتاب، اجتهدت الكاتبة “في تمهيد السبل إلى الله تعالى. فكانت ثلاثة، رتبتها من أيسرها إلى أعسرها: طريق العمل، وهو سبيل يغلب عليه الإجرائي، فطريق الرضا، وهو سبيل يغلب عليه النفسي، فطريق الذكر وهو سبيل يغلب عليه الفلسفي. نقول: “يغلب” لأن هذه السبل جميعها يتداخل فيها الإجرائي والنفسي والفلسفي سعياً إلى قول ما لا يقال.” (ص. 13)
وقبل التعمق في كل إشارة، أضافت الكاتبة إشارة بسيطة لا تتخطى الصفحة الواحدة، فكانت هذه الإشارة بمثابة تخليص لروح هذا السبيل. تنص إشارة سبيل العمل على التالي: “هذا طريق العمل، العمل لوجه الله. والعمل لوجه الله هو أن تعمل ما عليك عمله، وتطرح عنك النتائج والأسباب والمسببات والأبعاد والدلالات. العمل لوجه الله هو أن تقتنع عمقاً بأن محياك ومماتك لله رب العالمين. والعمل لوجه الله هو أن تنفذ إلى أنك لا تملك شيئاً ولا يمكن أن تعطي شيئاً. أنت فقط مجرد حلقة وصل في الحياة لا تعرف ماذا أخذت ولا ماذا أعطت. أنت صورة عابرة وأثر خالد.” (ص. 19)
وفي تقديمها لسبيل الرضا، تقول: “هذا طريق الرضا. هو طريق القبول بمشيئة الله تعالى ليس بما هي المشيئة الأفضل في رأيك ولكن بما هي المشيئة الوحيدة، وإن توهمنا خلاف ذلك. ولعل الرضا هو معنى الإسلام اللغوي والجوهري، فالإسلام هو التسليم بإرادة الله تعالى. طريق الرضا هو طريق الوعي بأنه أينما نول فثم وجه الله، ومثلما كان أحد الصحابة يقبل القرآن ويبكي قائلاً: “هذا كلام ربي”، فيمكن أن تحضن العالم المحيط بك بكل ما فيه وكل من فيه، وتقول: “هذا وجه ربي”.” (ص. 61)
أمّا السبيل الأخير، سبيل الذكر، فعرفّته بالتالي: “هل يمكن أن ينسى الإنسان البديهي؟ ومع ذلك ننسى. ننسى أن كل المواضيع فانية. ومع ذلك نبني على أرض هشة عمارات شاهقة وبنايات فاخرة ننسى أنها ستتساقط يوماً ما. المشكل ليس أن نبني، المشكل يبدأ عندما نصدق أن بناياتنا خالدة، المشكل يكبر عندما نتصور أن عمارتنا هي الجوهر. الأطفال يبنون على الرمل قصوراً جميلة يمضون ساعات في تشكيلها وتزويقها. وآخر اليوم، يحطمونها قبل الرحيل وهم ضاحكون مستبشرون. ذلك أن الأطفال يرون الحياة لهواً ولعباً. الأطفال نفذوا إلى أن اللعب أهم من البناية. الأطفال نفذوا إلى أن كل من عليها فان وأنه لا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام.” (ص. 151)
وتختم الكتاب بمعنيين عظيمين، أوّلهما: “إننا لا نعمل إلا لوجه الله، ولا نرى إلا وجه الله، وليست هويتنا الجوهرية إلا وجه الله. إذا كانت هذه هي الحقيقة، والحقيقة لا ثاني لها، فما جدوى التذكير بها؟ … للإجابة عن هذا السؤال، نستحضر حكاية الملكة التي تبحث في كل مكان عن عقدها، فإذا بها تكتشف بعد بحث مضن أن العقد حول جيدها. وجه الله، بمثابة العقد، والعقد موجود في جيد الملكة منذ البدء. المشكل أن الملكة نسيت أو غفلت. طريق العمل والرضا والذكر، شأنها شأن عقد الملكة، هي طرق نسلكها بالضرورة. ولكن، مثلما أن البحث عن العقد هو الذي يذكر بأن العقد حول الجيد، فإن الوعي بهذه الطرق الثلاثة هو الذي يذكر بوجه الله تعالى…علنا في ختام البحث نتبين أن لا معنى للبحث عما لا وجود لسواه.” (ص. 207)
وثانيهما ربطها بين وجوهنا الشخصية ووجه الله عز وجل، فتقول: “وجهك البشري ليس أنت، ذاك الوجه مجرد صورة يدركها الغير. وجهك الحقيقي هو ما به أنتّ ترى الكون. وجهك الحقيقي هو ما يمكنك من أن تقول: “ذراعي تؤلمني” أو “هذا صوت رقيق” أو “السماء صافية”… وجهك الحقيقي هو ما به تدرك كل شيء. وجهك الحقيقي لا يختلف في شيء عن وجه الآخرين الحقيقي. وجهك الحقيقي جواني، لا يمكن أن نصفه، لكن لنقل إنه ذاك الانفتاح الذي يمكنك من أن تحضن كل شيء في الكون. هو اتساع لا يُحد، لا بداية ولا نهاية، هو اتساع لا شكل له ولا حدود ولا خصائص مادية أو غير مادية. وجهك الحقيقي لا يوصف لأنه ليس موضوعاً. ومع ذلك، فلا يمكن فصله عن كل المواضيع التي ندركها به. هل تسمح لي صديقي القارئ بأن أقول إن وجهك الحقيقي هو وجه الله؟ أسلم وجهك لله، فوجهك البشري حدث عارض، ووجهك الألوهي هو الجوهر. “مزق عنك قناعك فوجهك غاية في الروعة والبهاء”.” (ص. 210)
الحكمة من الكتاب:
الحكمة من الكتاب وأجمل ما فيه هو إعادة الإنسان إلى حجمه الحقيقي؛ إلى كونه مجرد سبب، وأن الله -سبحانه وتعالى- هو المسبب والمحرك دائماً. كل أفعالنا وتصرفاتنا ومشاعرنا، ما هي إلا من أقدار الله ومخططاته. لذا فحتى الماضي الذي قد نؤنب أنفسنا في أحيان كثيرة عليه، أو نلوم غيرنا في أحيان أخرى، ما هو إلا جزء من قضاء الله عز وجل.
ففي مستوى الباطن، فإن “الحياة تكتب كما شاء الله تعالى لها أن تكتب. وإن نحن إلا أقلام يكتب الله تعالى بها الحياة. ومهما تقس على نفسك، أو على غيرك، فهو دور لازم في ملهاة الحياة.” (ص. 137)
اقتباسات من الكتاب:
“طيلة حياتي، كنتُ مسكونة باعتقاد عميق مفاده أن أكثر الأفكار تعقيداً يمكن أن يعبر عنه بأبسط الألفاظ والعبارات. وإذا لم تنجح في إفهام الغير، فمعناه أنك أنت غير متمكن من الفكرة.” (ص. 12)
“كيف تعبد الله أو كيف تعمل دون أن تكون طامعاً في أجر بشري أو إلهي؟ ننزعج لأن ذاك ما علمونا إياه. ننزعج لأننا أُقصينا من فطرتنا البسيطة. العمل لوجه الله بسيط جداً. ليس معناه أنك لن تحصل على أجر، معناه أن عليك فقط أن تعمل، وتترك نتيجة العمل لله. والفرق شاسع جداً بين أن تعمل وتحصل على أجر وبين أن تعمل من أجل الأجر.” (ص. 29)
“من الأحاديث الشائعة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك”، وهذا الحديث يجد صدى له في قولة شهيرة تنسب إلى ابن عربي حيناً، وإلى البسطامي حيناً آخر: “تقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان، وأقول حدثني قلبي عن ربي. تأخذون علمكم من الأموات، وأخذ علمي عن الحي الذي لا يموت”. يعسر تحديد المعني بالقلب لتعدد الاستعمالات المجازية. الأكيد أننا لا نعني بالقلب هنا الانفعالات المتشنجة مهما تكن وكيفما تكن، ولكننا نعني به إحساساً عميقاً يتجسم يقيناً. كلما بدا الفعل يقيناً هادئاً صادراً عن الأعماق، كان أقرب لأن يكون فعلاً قلبياً، ومن ثم عملاً صالحاً.” (ص. 33)
“إذا كنت لا تملك مالك وجسدك، وإذا كان كل شيء قد وهب لك مجاناً، وإذا كنت لا تعرف مدى ما تفعله ولا نتيجته، فكيف يمكن أن تتصور أنك “أنت” الذي تعطي فضلاً عن أن تنتظر جزاء؟ إن العطاء يمر عبرك، وأنت مجرد وسيط لا فضل لك في شيء.” (ص. 44)
“يمكن أن تفهم “إنا لله” على أساس أن الإلهي هو وحده الموجود الحق، أما البشرية فتجل عرضي فان لا يلبث إلا أن يرجع إلى جوهره الحق. الأنا البشرية لا تحيل إلا على فراغ؛ لأنه “لا أحد يقول أنا على الحقيقة إلا الله وحده” [نقلاً عن الحلاج].” (ص. 51)
“الأثر يعطي للأثر. الأثر يعمل من أجل الأثر. ولا أحد يحكم شيئاً. من هنا، ومهما يكن اختلاف الآخر عنك، فإنك عندما تعمل من أجل الآخر، إنما تعمل لنفسك. و(إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) [الإسراء: 1]. هذا ما تثبته البوذية أيضاً في إقرار شائع: ما تفعله للآخرين أنت تفعله لنفسك.” (ص. 53)
“السؤال الهوسي الذي يطرحه الغيور هو: “لماذا ليس أنا؟ لماذا نجح أبناء صهري بتفوق ولم تحصل ابنتي إلا على أعداد متوسطة جداً؟ لماذا رفضت بنت الجيران الزواج مني، لماذا فضلت عليّ خطيبها؟” الأمثلة لا تعد، ويبقى السؤال: “لماذا ليس أنا؟” دون أي إجابة مقنعة للغيور. لعل هذا السؤال لا يقتضي إجابة، أو لعل إجابته هي سؤال أخر، وهو: “لماذا أنا؟” ابنتي لم تنجح بتفوق، لكن لي ابنة لعلها تثير غيرة من لا أبناء له. كتابي لم يحصل على جائزة، لكنه وزع بشكل جيد. ابنة الجيران لم تقبلني زوجاً، لكن لي شغل قار دخله محترم. لماذا أمتلك هذا كله؟ ليس هناك جواب منطقي، هو عطاء، هبة من الكون. ولكننا ننسى. نتذكر فقط ثقافة الحق التي ابتلي بها الإنسان، وهي الثقافة التي تحمله على النظر إلى ما في أيدي الآخرين وكأنه حق انتزع منه، هي نفس الثقافة التي تجعله ينسى ليس فقط ما وهب له، وإنما ينسى أن كل هذا وُهب له مجاناً.” (ص. 56)
“أستحضر عبارة بالفرنسية… ترجمتها بالعربية: “الإنسان يدبر والله يقرر”، وأستحضر شبيهاً لهذه العبارة بالعامية التونسية: “أعمل اللي عليك والباقي على ربي”. هذه العبارات وسواها كثير تقتضي أن العمل البشري هو شراكة بين الإنسان والرب. جزء يسند للمخلوق وجزء يسند للخالق. لكن، ألا ترون معي أن هذه “الشراكة” في الفعل سخيفة بل مضحكة؟ إنها كذلك لسببين: أولاً، لأنها “شراكة” تقتضي أن الرب والعبد كلاهما فاعل. هما في نفس الدرجة تقريباً، رغم أن القرار الأخير يعود للرب. فكأننا نقول: عندما يحقق الإنسان نتيجة فعله، فهذا يعني أن “مشيئة” الإنسان تحققت، وكذلك تحققت مشيئة الله. وعندما لا يحقق الإنسان نتيجة فعله، فهذا يعني أن “مشيئة” الإنسان لم تتحقق، وإنما تحققت فقط مشيئة الله تعالى. في كل الحالات إذن، عمل الإنسان لا يحقق مشيئة الإنسان إلا أحياناً، ولكنه يحقق مشيئة الله دوماً. أليس واضحاً هنا أن لا وجود إلا لمشيئة واحدة هي مشيئة الله تعالى، أليس واضحاً أن المشيئة البشرية مجرد وهم؟ ثانياً، وهذا هو الأهم، إن الإقرار بأن العمل من شأن العبد ونتيجة العمل من أمر الرب هو سفسطة ذات هدف بيداغوجي. يكفي أن نتذكر أن العمل “الاختياري” البشري ذاته هو نتيجة لأعمال سابقة، وهذا ينزع عنه صفة “الاختيار”، فيحوله بدوره إلى عمل “إجباري” لاندراجه ضمن سلسلة السبب والنتيجة. نوضح هذه الفكرة بتمثيل بسيط… الشخص الذي بذل جهده من أجل النجاح في أحد الاختبارات. ظاهرياً، الشخص يختار عمله، وهو هنا أن يبذل مجهوداً في الدرس أو أن لا يبذل. لكن في واقع الأمر، فإن بذل الجهد نفسه متصل بعناصر سابقة: نفسية ذلك الشخص، ظروفه، ما رسب في لا وعيه، حالته الصحية، وكل ما ساهم في نحت شخصيته وسلوكه. وكذا شأن الشخص الذي ضرب آخر فقتله. ظاهرياً، الشخص يختار أن يتحكم في غضبه، ويختار قوة الدفعة. لكن في واقع الأمر، فإن الغضب متصل بسمات جينية وتجارب نفسية، وحدة الضربة متصلة بقوة عضلات الضارب وبسياق الخصومة وسواها من العوام التي لا حصر لها ولا حد.” (ص.65 – 67)
“أفضل أن أصدم القارئ من الآن، وأخبره أن لا وجود لأي فعل بشري حر. إن الحرية تفترض أنك سبب أول ولستَ نتيجة لسبب سابق، وهذا ما لا يتصف به الإنسان الذي هو ثان في الكون أنطولوجياً. الوحيد الذي لا يكون إلا حراً هو الله تعالى. وسنرى لاحقاً أن حرية الإنسان لا تكون إلا في خضوعه لحرية الله تعالى أو بعبارة أخرى في عبوديته لله تعالى. بل لعلنا نصدم القارئ أكثر إذ نذكره أن كل الأفعال المتحققة في الكون هي من إرادة الله تعالى لا من إرادة البشر، وإلا لما تحققت.” (ص. 68)
“لا أحد يعمل شيئاً حباً في الشر، وإنما يعمل الناس من أجل الخير كما يتصورونه [نقلاً عن غوردجييف (Gurdjieff)].” (ص. 77)
“الفهم العميق لنسبية الخير والشر لا يقوم على تحديد الخير والشر، وإنما على الإقرار بعدم القدرة أصلاً على تحديد الخير والشر.” (ص. 81)
“من منظور البشر التأويلي، الحدث نفسه قد يكون خيراً وشراً وفق وجهات النظر. ولكن الحدث هو دوماً خير من المنظور المطلق، فـ “الخيرة فيما اختاره الله”، هذا ما ينساه الإنسان أحياناً.” (ص. 82)
“لما كانت الحقيقة كائنة، فإن نفيها فعلياً أمر مستحيل. ولا يمكن نفيها إلا ذهنياً بإنشاء عالم وهمي عن الكائن الذي يزعجنا. هذا العالم الموازي يقول بأعلى صوته: لقد أخطأ الله، اللحظة الحاضرة ما يجب أن تكون على هذه الحال، بل يجب أن تكون على حال أخرى أنا أدرى بها.” (ص. 89)
“إن الرضا مرتبة تلي مرتبة الصبر. الرضا صبر بلا تأويل ولا تفكير ولا إعمال نظر ولا تساؤل. الصبر قد يكون عقلياً، أما الرضا فليس إلا قلبياً.” (ص. 101)
“إن الله لا يمكن أن يريد بنا شراً. يكفي فقط أن نفهم أن كل ما يجري لنا ينفعنا إن لم يكن بشكل آني مباشر، فسيكون بشكل زماني غير مباشر. كل ما يجري لنا هو عطاء ممن يحبنا أكثر من أنفسنا.” (ص. 116)
“الرضا لا يمنع الألم، ما في ذلك شك. ولكن الرضا يمنع العذاب، ما في ذلك شك أيضاً. ما الفرق بين الألم والعذاب؟… الألم فيمكن أن يكون جسدياً أو نفسياً، وأما العذاب فينتج عن رفض ذلك الألم. بعبارة أخرى، العذاب هو في تصور أن الألم ما كان ينبغي أن يكون.” (ص. 123)
“أحد الفلاسفة يقول: لا تكن قاسياً في حكمك على الآخرين، فقد يكون طريقهم أشد مشقة من طريقك.” (ص. 133)
“إن الحكم الجاد الجامد القاسي على أنفسنا هو … حكم فاسد.” (ص. 135)
“لو انتبهنا قليلاً ونظرنا في أنفسنا نظرة وصفية هادئة محايدة للاحظنا أن جل ما يستفزنا للحكم على الآخرين بعنف هو مما نحمله في أنفسنا بدرجات متفاوتة ودونما وعي في أغلب الأحيان.” (ص. 141)
“لماذا يعاقبنا الله تعالى إذا كان ما نفعله من إرادته؟ أليس هذا ظلماً؟ أين العدالة الإلهية؟ “… إن طريق الرضا يقوم على حب الله تعالى بوجوهه: حب العرفان وحب الثقة والحب الخاص. من يبلغ الرضا، بل حتى ذاك الذي يسير في سبيله، لا يطرح هذا السؤال. بل لا يطرح أي ضرب من ضروب أسئلة: “لماذا؟” (ص. 146)
“ما الذي يسمح لكل واحد منا بأن يقر أن الأنا هو الأنا، رغم كل ضروب التغير وصنوف التبدل؟… من يسمح لنا بأن نكون موقنين يقيناً لا يزعزعه شك ديكارتي بأن هناك استمرارية ما، بأن هناك تسلسلاً ما يشد جميع مراحل حياتنا، ويخول لنا أن نقول “أنا”؟ من يسمح لنا بذلك هو ما لم يتغير فينا. من يسمح لنا بذلك هو من شهد الحكاية كلها من بدئها إلى منتهاها في هذه الحياة. ونزعم أنه سيشهدها حتى بعد الموت. هذا الذي لا يتغير هو العين التي أبصرت الحكاية. هي ليست عين الحس، ولكنها عين الروح، الأولى ترى في المرآة، والثانية لا تُرى لأنها هي التي ترى كل شيء.” (ص. 155)
“يروق لي أن أسمي… الوعي التام بعبارة أخرى أقرب إلى نفسي، وهي عبارة الخشوع. الوعي بكل شيء هو خشوع أمام جميع هبات الحياة، وكل شيء هبة. الوعي بكل شيء أو الخشوع لا يكون إلا لحظة الحاضر. أما القلق أو الندم فلا يكونان إلا عندما نبتعد عن لحظة الحاضر نحو ماض رحل ولن يعود أو مستقبل لا نعرف عنه شيئاً.” (ص. 157)
“إنه لا وجود لموضوع خارجي في الكون يمكن أن يشبعك… لماذا؟ لسبيين: أولاً، لأن السعي نحو المواضيع الخارجية يكون على خط الزمن، أنت ظاهرياً تريد شيئاً اليوم، وتنشد شيئاً آخر غداً، وتشتهي شيئاً ثالثاً بعد شهر، وهكذا ودواليك. أما جوهرك فهو الشاهد الحاضر أبداً لا يتغير ولا يتبدل… ثانياً، المواضيع الخارجية التي تنشدها بكل لهفة، تقتضي أنك ناقص، وأن موضوعاً خارجياً سيلغي ذلك النقص. المواضيع الخارجية التي تسعى إليها تضمر أنك فارغ وأن موضوعاً خارجياً سيملأ ذلك الفراغ، والحال أنك كامل ممتلئ بذاتك. لا أعني حاجتك البشرية إلى الغذاء والماء والأكسجين وما إلى ذلك. أعني أنك في كل الأحوال كائن، وليس هناك “كائن ناقص”. أنك ناقص هي فحسب فكرة تعلمتها حتى توهمت أنها حقيقتك. أذكر أن بعثة من الأنثروبولوجيين زارت إحدى القبائل “البدائية” كما يقولون. وسأل أحد أفراد البعثة بعض أفراد القبيلة قائلاً: “ما الذي ينقصكم؟” فأجابوه: “ما معنى ينقصكم؟”. (ص.159- 160)
“إن عبارة “بأعيننا” في الآية [(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) سورة الطور: 48] هي مجرد إقرار بسيط أننا دوماً، أنى اتجهنا، ومهما تقلبنا ومهما تنوعت تجاربنا حد التناقض أحياناً، في حضرة الإله.” (ص. 162)
“يُنسب حديث: “من عرف نفسه عرف ربه” إلى الرسول، وإلى علي بن أبي طالب وإلى سواهما أحياناً. هذا الحديث لا يحيل على المعرفة بما هي النفاذ إلى عنصر خارجي جديد. إن المعرفة المقصودة هنا هي معرفة جوانية بديهية. هي معرفة يشترك فيها البشر جميعهم، من لا يعرف أنه موجود؟ من لا يعرف أنه كائن، من لا يعرف أنه الشاهد على كل مجريات الحياة؟ هل يحتاج هذا الأمر البديهي إلى دروس ونظريات وأبحاث؟ قطعاً لا. المشكل متصل فقط بنسيان المعرفة البديهية، الإنسان ينسى أنه الشاهد، أي إنه ينسى جوهره الألوهي. ولما كان هذا الجوهر الألوهي حاضراً أبداً، فإننا نحتاج فقط إلى تذكره. من هنا كانت “المعرفة تذكراً والجهل نسياناً”.” (ص. 169-170)
“الوجود الجوهري الوحيد هو وجود الله تعالى، أما سائر الموجودات فحادثة، ووجودها عرضي، وهدف وجودها الوحيد هو معرفة الله تعالى.” (ص. 173)
“إن الله تعالى هو الذات الأصلية الجوهرية، والكون كله مواضيع تشير إليه. والإنسان ليس إلا واحداً من هذه المواضيع القائمة في الكون. لا يتعلق الأمر هنا بثنائية كلاسيكية بين ذات وموضوع مستقل أحدهما عن الآخر. إننا نتحدث عن ذات واحدة لها الوجود الجوهري، أما سائر المواضيع الفانية فليست إلا تجسما عرضيا لها. هذه الذات هي العارف الوحيد، ولا يمكن أن تكون موضوعاً للمعرفة. وهذا العارف الوحيد لا يكون إلا بالمعروف، والمعروف لا يكون إلا بالعارف. الفصل بينهما تفرضه علينا اللغة التي تقطع الكون. أما عرفانيا، فلا وجود إلا لله تعالى وحده، فهو العارف والمعروف.” (ص. 175)
“إن قانون الجذب يجسم ما تثق في حصوله فعلاً هو كأن تقول – بمعجم آخر وسياق مختلف – إن الله تعالى يستجيب إلى دعاء حسن الظن بالله الواثق من الاستجابة. لقد أشرنا إلى أن إرادة الله تعالى وحدها هي التي تسري في الحياة، فإذا كانت ذبذبة إرادتك الصورية الوهمية على نفس تردد ذبذبة إرادة الكون، تجسم ما تريده ضرورة.” (ص. 181)
“إن هويتنا هي الجوهر الإلهي فينا، هويتنا الأصلية هي الذات المطلقة المدركة، وهذه الذات المطلقة لا يمكن أن تتحول موضوعاً وإن يكن موضوعاً للترميز اللغوي.” (ص. 187)
“ألم يكن من الممكن أن يخلق الله تعالى عالماً بلا مرض ولا آلام ولا زلازل ولا حيوانات مفترسة؟ أطنبنا في الحديث عن عوالم الذهن الموازية التي تنأى بنا عن الحق، وهذا الضرب من الأسئلة تجسيم نموذجي لها. أكيد أنه يمكن تقديم أجوبه لهذه الأسئلة، لكنها شأن الأجوبة جميعها تظل مجرد إمكانات تأويلية وقراءات ذهنية وتخيلات نظرية. ذاك هو الكون كما هو… يمكنك أن تتخيل واقعاً مختلفاً، يمكنك إذا استطعت أن تصنع واقعاً مختلفاً. لكن لا يمكنك بحال أن تنفي ما هو كائن.” (ص. 202-203)
“الحق أنه لا يمكنك أن تغادر طريق الحق لأنك أنت الحق. يمكن أن تنسى، يمكن أن تتوهم أنك بعيد ومستقل عن كل الموضوعات، ولكن أوهامك لا يمكن أن تنفي أنك اللاشيء الذي يحتضن كل شيء. سنوات البحث جميعها لن تسمح لك بأن تضيف شيئاً إلى ما هو موجود، هي فقط قد تمكنك من أن تغادر عالم الوهم والغفلة إلى نور اليقين. الأصل أن لا وجود إلا للموجود الحق أي الله تعالى. لا يمكن أن تكتشف الموجود الحق لأنه قائم بالقوة وبالفعل، فقط يمكن أن تكتشف أن سائر الموجودات الأخرى مجرد أوهام، وعندما ينتهي الوهم لا تبقى إلا الحقيقة.” (ص. 208)
الختام:
عادةً، لستُ من محبذي قراءة الكتاب أكثر من مرة، فبعد قراءتي الأولى والمتعمقة دائماً، أعجز عن العودة إلى ذات الأفكار والمعاني مجدداً، ولكن بعض الكتب الاستثنائية، ونظراً لما تحمله من عمق وتذكير وحكمة، تتحتم قراءتها أكثر من مرة واتخاذها مرجعاً. ينتمي كتاب ألفة يوسف «وجه الله: ثلاثة سبل إلى الحق» إلى الفئة الثانية بالتأكيد.

أحدث التعليقات