الصفحة الرئيسية / مراجعات / مُختارات / رواية «الجنسية» لمعتز قطينة
معتز قطينة شاعر وصحفي فلسطيني ولد في القدس ونشأ في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة. بدأت رحلته مع القلم في سنة 1997 حيث نُشرت له العديد من المقالات والنصوص في الصحافة السعودية. صدر له ثلاثة دواوين شعرية: «خلفي الريح مجدولة» سنة 2002 و «أوجاع الذئب الأشقر» سنة 2004 و«عصيان» سنة 2007. في شباط سنة 2010 نشرت دار أزمنة للنشر والتوزيع في الأردن روايته الأولى «الجنسية». والرواية أقرب للسيرة الذاتية منها للرواية بمعناها الدارج، فهي تصور للتجربة الشخصية للكاتب الذي عاش ممزقاً بين وطن ينتمي إليه وآخر يسكنه.
رواية «الجنسية» هي قصة الهوية في صراعها الأخير مع جيل عربي قد سأم الوطنيات والهويات الموروثة. لقد احترقت ورقة الوطن منذ فترة طويلة منذ أن أصبحت أداة يستخدمها الأقوياء غالباً لطحن الضعفاء أو هكذا هو الحال في العديد من الدول.
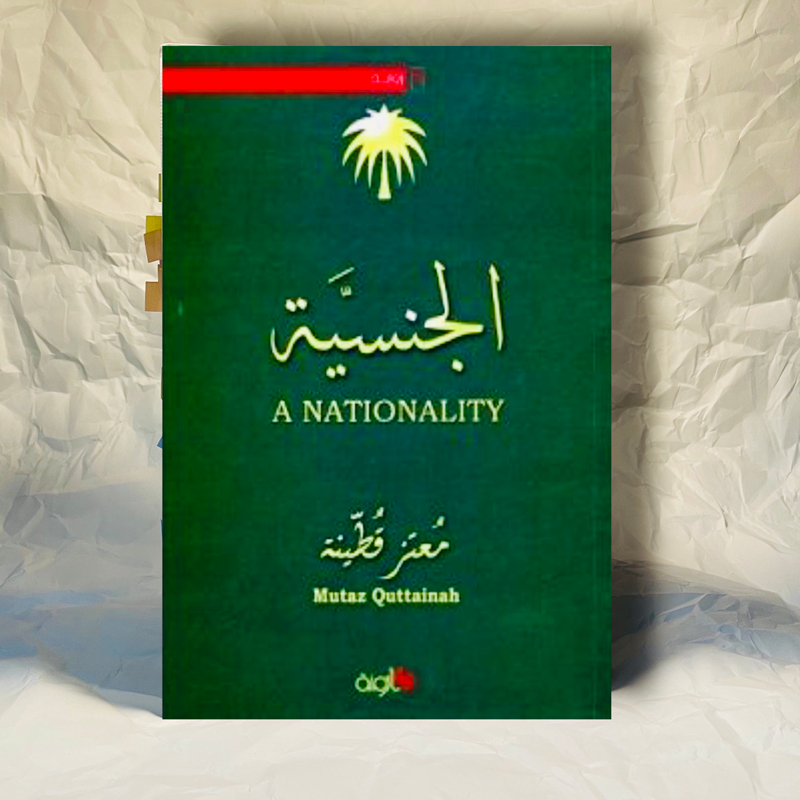
فلسان حال الجيل الجديد يقول: نحن من نحن ومن نريد أن نكون، أوقفوا هذه العبودية! أجل إنها عبودية أن يُصنف الإنسان استناداً لجنسيته أو يتوقع منه تصرفات معينة لأن له جوازاً من بلد معين والأشد عبودية في هذا كله عندما يطلب من الشخص ذاته وربما يرغم على التصرف بصورة معينة استناداً لجنسيته أو هويته التي ورثها. وطالما لا تزال المجتمعات العربية تفكر بهذه الصورة وتورثها فسيبقى مواطنو هذه الدول عبيداً لجنسياتهم وأصولهم.
وتبقى قضية الهويات والوطنيات الحديثة مرتبطة بنقطة محددة في تاريخ البشرية وهو التاريخ الذي قطعت فيه الكرة الأرضية لأجزاء عديدة وأخرجتها من طبيعتها الأولى الجامعة لحال بائسة تصنف البشر استناداً لمكان ولادتهم أو تبعا لخيار آبائهم وأجدادهم. أين هي الحرية التي يتحدث عنها الجميع إن لم تكن حرية التنقل في الأرض الواسعة التي خلقها الله عز وجل لنا جميعا على مختلف أصولنا وأدياننا وانتماءاتنا؟
ويعبر الراوي بكل أريحية على هذه التساؤلات فيقول: “كيف عشت كل هذه السنين دون أن أثبت أنني أنتمي إلى المكان الذي أنا منه: من أين أنا؟ وكيف صرت ابن هذه الأرض؟! هل أنا أحب مكاني الذي تشكلت فيه أكثر؟ أم أنني أحب المكان الذي حملت اسمه أوراقي الثبوتية؟ أم أنني أنتمي إلى وهم لم أتعرف إليه بعد…!” (ص. 11-12)
في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ونتيجة للآراء التي عمت الفكر الإنساني ( والأوربي خاصة) ولدت الدولة القومية بصورتها الحديثة كتعبير قانوني للأمة أو الوطن على مساحة جغرافية محددة ترجمت على أرض الواقع بالحدود السياسية غير أنها مجرد حدود وهمية من صنع البشر ولا وجود لها في الأصل ولا أهمية فعلية لها سوى التزام الدول والأشخاص بها.
“لقد انتشرت الأفكار القومية الأوربية في القرن التاسع عشر بصورة ألهبت المشاعر وأعطت قدسية وربما ألوهية لفكرة «الوطن» و «الأمة» و «القوم». وقد أدى ذلك اللهب القومي لاحقاً إلى نشوء حركات عنصرية ووصول الحكم النازي في ألمانيا والحكم الفاشي في إيطاليا بعد الحرب العالمية الأولى.” (الجمري، 2007)
لكن الحكومات الشمولية (الدولة النازية والدولة الفاشية) ليست النتيجة الوحيدة للتقسيم “الوهمي” للأرض بل لأن الشعوب أنفسها تبنت هذا الموقف في العديد من الأحيان فنجد أبناء الدول المجاورة يسخرون ويتكبرون على بعضهم البعض بسبب ولادة أحدهم في هذه الأرض والآخر في الأرض المجاورة لها بينما لا تفصلهم سوى مسافة صغيرة جداً تكاد لا تُذكر لولا الحد السياسي الذي يفصل بين هاتين الدولتين وغيرها العديد من الأمثلة التي تصل في أحيان كثيرة للقتل والحرب بسبب خط وهمي.
ونجد أن الراوي ذاته ساخط على هذا التقسيم الوهمي الذي غالبا ما كان يقع بينه “الفلسطيني” وبين الآخرين من مختلف الجنسيات ويقول بوصف هذا “السور” الذي نشأ بين الفلسطينيين والسعوديين: “ليس من السهل تفنيد أسباب هذا السور الذي نشأ بين الفريقين، إذ إن كلاً منهما في ملكوته يظن بأفضليته، يؤمن الفلسطينيون أنهم أكثر وجاهة وعلماً وثقافة! وأن لهم الفضل الكثير في تغيير البلد، وعلى النقيض ينظر السعوديون إلى الفلسطينيين باعتبارهم أقل شأناً وأنهم حفنة من المرتزقة اللاجئين!” (ص. 40 –41)
وعلى الصورة المحددة التي يفترض عليه أن يعيش في نطاقها تبعاً لكونه فلسطينياً بالوراثة فيقول: “لماذا يظنون أن الهوية حق حصري لهم يتوجب عليهم منحه لأبنائهم دون أن تكون لهم الحرية في تقرير هوياتهم؟” (ص. 45)
ويتسمر في نقد هذه الصورة فيقول: “لم تتوقف أسرتي طوال هذه السنوات عن ترسيخ مفهوم الغربة في أذهاننا، إننا أغراب، ومنقطعون عن هذا العالم، ليس لنا في هذه البلاد قريب ولا معين، ولا يمكننا الاستمرار في العيش هنا، هل يمكن لنشرة الأخبار وحدها وصور الشهداء المنثورين كل يوم أن يخلقوا ارتباطاً بعالم لا أعيشه؟! أي المبررات يمكنه أن يشدني إلى بلاد لا أراها، وأناس أحل عليهم ضيفاً كل عام؟!” (ص. 57-58)
وهل يمكن للإنسان أن ينتمي لقضية؟ لطالما كانت فلسطين قضية الشرق الأوسط وقلبها النابض ومن انتفاضة لأخرى تنتفض الشعوب العربية حسب وعيها منددة بما يفعله الاحتلال الصهيوني كما يحدث حالياً بينما يترقب العالم ولادة انتفاضة ثالثة، لكن السؤال يبقى: وماذا عن هؤلاء الفلسطينين؟ هل يذهبون جميعهم ضحية الوطن؟ وهل هذا معقول؟ وهل هذا إنساني؟ كيف يمكن للإنسان أن يعيش وسط حدود قضية أينما ذهب فكأنما يحمل خريطة بلده على ظهره، وماهي نتيجة حمل كهذا؟ ألن يرهقه ظهره مع مرور الزمن؟
ويقول الراوي بهذا الشأن: “لم تقدم القضية الفلسطينية إلا باعتبارها قضية أمة، وقضية شعب، وظلت قضية الفرد الفلسطيني في الأرض المحتلة والمنافي المتعددة أزمة مغيبة، وإنسانية محشورة وسط مصائر الآلاف من مماثليه، فحين يقدم قضيته يتورط الفلسطيني بكينونته وذاته، ويتحدث باسم شعب كامل مشتت مجتمع في اسم، هذه أزمة لم ينج منها الساسة ولا المفكرون ولا عاملوا المصانع ولا الشعراء والفنانون حتى!” (ص. 102)
ويقول في حوار له مع صديقه الفلسطيني رضا: “فلسطين ليست لك، وبيتكم الذي ما زال مغلقا في غزة، والذي أكل الدهر وشرب على مفاتيحه التي ورثتها ليست لك أيضا، أين تذهب أيها الفلسطيني الناحل الذي لا يجيد إلا التباهي بفلسطينيته، وفلسطين لا تجيد أن تضمك من ترابها لو تخلصت روحك من جسدك!” (ص. 84)
ولعل القضية الحقيقة التي تثيرها رواية «الجنسية» هي الفرق الشاسع بين المبدأ والفكرة في نطاقه النظري وبين امتداد هذه النظرية ونتائجها في الواقع المحسوس الملموس. الوطن كمبدأ وكفكرة طوبيه يبدو لازماً ولابد منه، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك ففي العديد من الأحيان نجده يقف عائقاً بين إنسانية البشر وتضامنهم كما كان الحال في العديد من الدول الأوربية.
يختار البطل أن يعيش في الواقع العملي ويفكر في مصلحته ورغبته الشخصية لا أن يعيش كرقم إضافي لشعب فلسطيني يعيش القضية أكثر مما يعيش يومه فيقول: “أنا لا أريد مكانا آخر لأعيش فيه غيرها [جدة]، وإن كنت أحب فلسطين، لكنني لا أريد العيش فيها. بلا استثناء ثار الجميع علي، واعتبروا هذا انسلاخا عن هويتي.” (ص. 112)
وبهذا تنتهي الرواية بولادة قدر جديد اختاره الكاتب لنفسه ولم يجبره عليه أحد ولم يرثه بالتأكيد كجزء لا يتجزأ من حلمه الثقافي. تتمثل هذه الولادة في المرأة السمراء التي كانت قابلته في القدس عندما ولد وهي أيضا رمز لهذا الحضور الأسطوري في مواضع مختلفة من الرواية، منها: “تحولت صالات الجسر إلى خلفية ثابتة لمشهد خرافي لا يطل منه سوى اليباب، وثمة صحراء تمتد حتى تشغل حيز البصر بأكمله، ومن بعد يكبر هيكل امرأة مقبلة نحوي، بشرتها غامقة مثل حبوب القهوة.” (ص. 30)
إذن يختم معتز روايته أو بالأصح سيرته الذاتية بمقابلته لهذه المرأة السمراء في شوارع جدة فكأنه بذلك يعلن تاريخ ولادته وتحرره فيقول: “ابتسمت حين رأيت امرأة سمراء … وحين أطلت النظر فيها همهمت بلغة إفريقية غير مفهومة كلاماً لم أفهمه، و مازلت حتى الآن غير مدرك معانيه، لكنه يبدو لي مألوفاً رغم أن عقلي ينكره…!” (ص. 126)ربما كانت هذه المرأة مجرد امرأة سمراء لا غير وربما كانت فعلاً رمزاً للولادة ولأصلنا الأول: أفريقيا والتي قد أصابها ما أصابها من هذا التقسيم “القومي”. تنتهي الرواية ويبقى السؤال.
أعجبتني الرواية فالحوار الداخلي الحي يخرج ما في الإنسان من تساؤلات وأحياناً من آلام عانى منها بسبب الهوية و”الوطن”، أنصح بقراءتها.
المراجع:
- منصور الجمري (2007/11/08) “ما الدولة القومية” صحيفة الوسط

أحدث التعليقات